«العالم قرية صغيرة» مقولة ابتذلت من كثرة ما جرى ترديدها للتأكيد على ما فعلته الثورة الاتصالية بعالم اليوم. ولكن يبدو أن «العالم قرية صغيرة» من زاوية أخرى يتشابه فيها هذا الركن وذاك في مآسيه الإنسانية الناتجة عن غياب المعاني الحقيقية «للمواطنة»، وحقوق الإنسان. هذا الغياب الذي يظل الملمح الرئيسي لإرث إنساني طويل من الاستبداد والديكتاتورية (دينية كانت أو شوفينية أو فاشية عسكرية)، واعتقاد هذا أو ذاك أنه دونا عن خلق الله أجمعين «يملك الحقيقة المطلقة».
ـــــــــــــــــــــــــ

عندما تغيب الديموقراطية «الحقة»، التي تعرف معنى «المواطنة» الحقيقية، وتحترم «حقوق الإنسان» لمجرد كونه إنسان، يحدث ما يحدث في ميانمار
الحديث عن «أهل الخير وأهل الشر» الذي ابتدعه يوما جورج دبليو بوش (وتبعه التابعون)، لا يختلف في جوهره عن حديث بن لادن عن «الفسطاطين». كلاهما حديث ميتافيزيقي ينفي الآخر، بدمغه ابتداء أنه من «أهل الشر»، ممهدًا الطريق دعائيًا لكل ما يلي ذلك من جرائم.
ما يحدث في ميانمار (بورما سابقا) من تهجير قسري وإبادة جماعية لمسلمي الروهينجا على يد السلطة العسكرية «المتحكمة» وجماعات متطرفة شكلها رهبان بوذيون، يحرقون القرى، ويرتكبون المذابح «تحت رايات الدين» (!) لا يبتعد عن ذلك كثيرا.
***
بعيدا عن حديثٍ تخندقَ (بحكم الهوية) في هذا المربع أو ذاك، مغترا بقوته (أو كثرته) عند الأغلبية ذات السطوة الدينية أو العسكرية هناك، أو مختزلا عند المسلمين هنا في بكائيات «التعديد»، أو بيانات التنديد، أو صيحات التنادي بالثأر على مواقع التواصل الاجتماعي، آثرت أن أنظر إلى الصورة في إطارها الأوسع، وأن أعيد قراءة التاريخ المعقد لشبه القارة الهندية. وأن أسترجع تاريخ الحرائق المأساوية الكبرى التي كانت «الهوية» دوما؛ دينية كانت أو قومية وقودها، في رواندا على سبيل المثال وفي يوغسلافيا السابقة، وفي العراق، وفلسطين التي نعرف، وفي ألمانيا النازية. ثم كان أن نظرت مرة أخرى في كتاب ابن القارة الهندية الأشهر (حامل جائزة نوبل) أمارتيا سن عن «الهوية والعنف» Identity and Violence: The Illusion of Destiny، Amartya Sen ــ Penguin ــ 2007
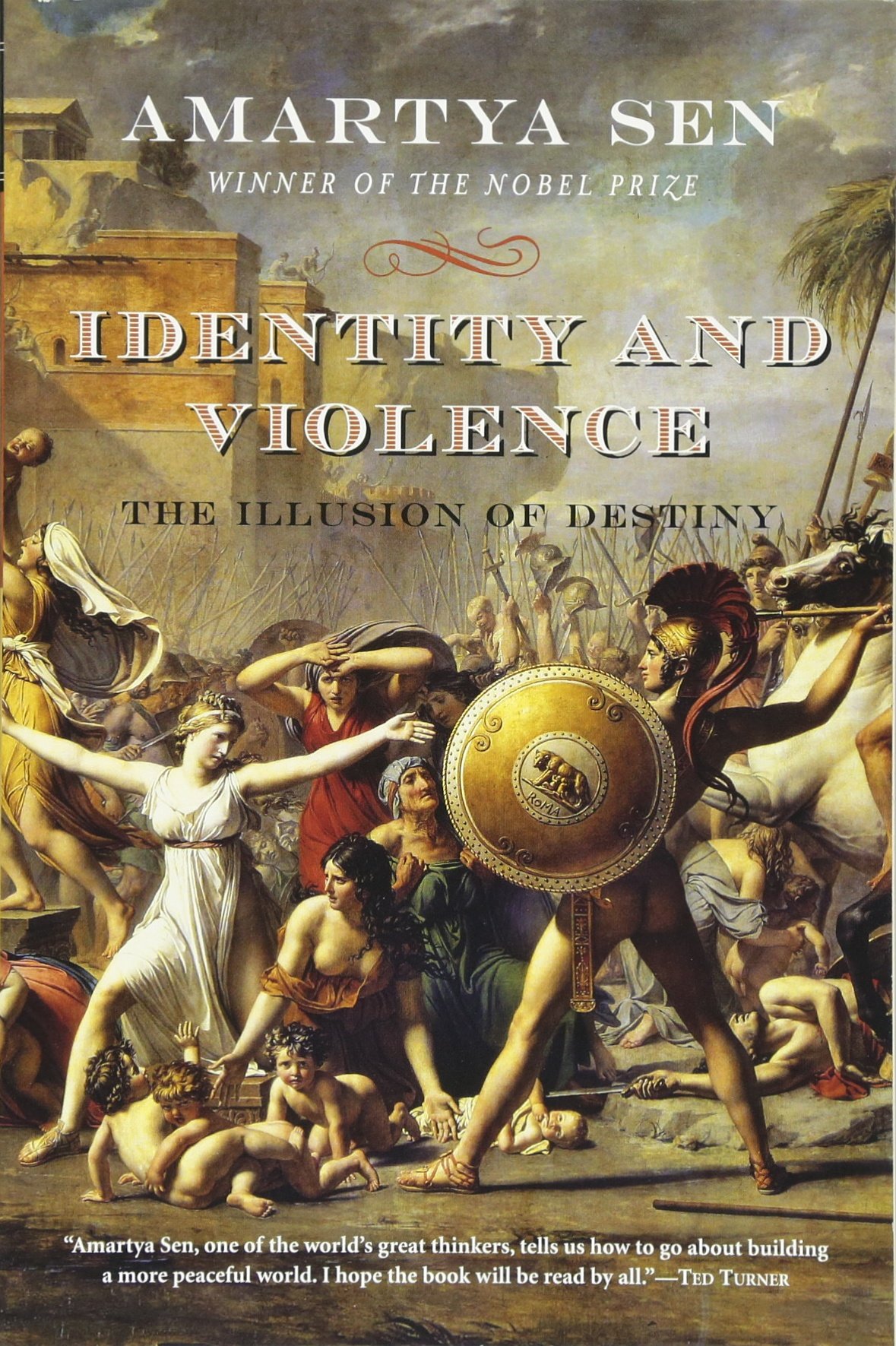 يحكي المفكر الهندي المرموق في كتابه بعضا من ذكريات طفولته عن الشغب بين الهندوس والمسلمين في الأربعينيات من القرن الماضي حول سياسات التقسيم. وكيف أن الناس الذين كانوا «بشرا» بشكل عام في يناير، تحولوا فجأة في يوليو إلى هندوس (لا يرون غير هندوسيتهم)، ومسلمين (لا يشعرون بغير هويتهم الدينية)، وكيف كان بمنتهى البساطة والسرعة أن فقد مئات الآلاف حياتهم، نيابة عن «جماعاتهم»، بعد أن نجح الساسة في استثمار هذا الاستقطاب «الهوياتي».
يحكي المفكر الهندي المرموق في كتابه بعضا من ذكريات طفولته عن الشغب بين الهندوس والمسلمين في الأربعينيات من القرن الماضي حول سياسات التقسيم. وكيف أن الناس الذين كانوا «بشرا» بشكل عام في يناير، تحولوا فجأة في يوليو إلى هندوس (لا يرون غير هندوسيتهم)، ومسلمين (لا يشعرون بغير هويتهم الدينية)، وكيف كان بمنتهى البساطة والسرعة أن فقد مئات الآلاف حياتهم، نيابة عن «جماعاتهم»، بعد أن نجح الساسة في استثمار هذا الاستقطاب «الهوياتي».
ثم يشرح لنا الكاتب في كتابه القيم كيف أن الهوية في طبيعتها الفطرية «مركبة»، وكيف يؤدي اختزالها في أحد جوانبها «تمييزا» إلى نفي الآخر (المشترك معنا أصلا في جوانب أخرى)، ومن ثم إلى إذكاء فرص الصراع والدماء.
وبعد أن يستعرض معنا وقائع تاريخية كانت علامات مؤسفة في تاريخ الإنسانية، يخلص أمارتيا سن إلى النتيجة التي نعرفها جميعا. أن الديموقراطية «الحقة»، التي تعرف معنى «المواطنة» الحقيقية، وتحترم «حقوق الإنسان» لمجرد كونه إنسان هي صمام الأمان الأوحد. وأن الديكتاتورية؛ دينية كانت أو قومية أو عسكرية توفر دوما المناخ الملائم لنمو «الهويات الاستقطابية»، وهو تعبير أحاول به أن أختصر ماقصده المفكر النوبلي في كتابه.
***
في فسيفساء قصة مسلمي الروهينجا اللا إنسانية الموجعة يختلط الإرث الاستعماري، بالديكتاتورية العسكرية، بأزمات ترسيم الحدود في عصر الدولة الحديثة
ربما لا تكون أزمة الروهينجا المتفاقمة منذ عقود مجرد انعكاس لأزمات الهوية التي يتحدث عنها سن. ولكنها بالتأكيد تقدم فهما لأحد جوانبها المهمة.
ففي فسيفساء قصة الروهينجا اللا إنسانية الموجعة يختلط الإرث الاستعماري، بالديكتاتورية العسكرية، بأزمات ترسيم الحدود في عصر الدولة الحديثة. ويتبدى بوضوح عمق الأزمة حين يختزل البعض مفهوم الديمقراطية في ما يمكن اعتباره في نهاية المطاف شكلا من أشكال «ديكتاتورية الأغلبية».
بدأت الأزمة تأخذ شكلها الحاد في منتصف القرن الماضي، مع نهاية الحكم البريطاني للمنطقة، وكان الروهينجا، الذين يتجاوز تعدادهم المليون أحد ضحايا ترتيبات «ما بعد الاستعمار». ففي تلك المنطقة من العالم، كما في شرقنا العربي جرى اختراع الدولة الحديثة ورسم حدودها على يد المستعمر، دون النظر إلى الاعتبارات الجيوسياسية الحاكمة، إلى آخر تفاصيل قصة نعرفها كما تعرفها إفريقيا والبلقان وشبه القارة الهندية.
في بداية الستينيات، ومع تركيز السلطة في البلاد في يد العسكريين، الذين أجادوا كالمستعمرين استخدام التناقضات الدينية، بدأ الاضطهاد «الممنهج رسميا» لمسلمي الروهينجا، والذي لم يسمح القمع الأمني ومصادرة الحريات في مقاومته، حتى من أولئك المثقفين أو الناشطين غير المسلمين. فكان أن عرفت البلاد الاستقطاب الحاد. ثم كان أن بدأت دائرة العنف «والثأر» والدماء.
«في التنوع ثراء» هذه هي أحكام الطبيعة والبيولوجيا.. وحتى الفلسفة والأديان «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً». ولكن ماذا يحدث عندما تفشل الدولة في إدارة التنوع بين مواطنيها؟ لا شيء غير ما شهده جيلنا من مآسي في بورما والعراق والسودان ودول يوغسلافيا السابقة.
عندما تفشل الدولة في إدارة التنوع بين مواطنيها، ويحل التهميش والإقصاء لنفر من مواطنيها محل المساواة والإنصاف العدل، يختفى الإحساس بالانتماء للوطن الواحد. وتعلو الانتماءات الأدنى للطائفة أو القبيلة أو الجماعة أو العائلة على الانتماء للوطن.
عندما تفشل الدولة في إدارة التنوع بين مواطنيها، توفر (بقصد أو دون قصد) الأرضية الخصبة لخطاب الكراهية، والتعصب.. والعنف، والدماء.
***

حيثما تعمقت ثقافة الاستبداد، تصبح «القوة فوق العدل»، بل وفوق الإنسانية ذاتها
على ما جرى (ويجري) فى ميانمار هناك ملاحظات كثيرة كما أن فيها دروس أكثر:
من الملاحظات أنه كما غابت أو كادت التغطية (الجادة) لمذبحة هي إنسانية في المقام الأول عن إعلامنا العربي مقارنة بإعلام الغرب، تقاعست كذلك مراكز البحث في البلدان العربية والإسلامية عن دراسة الموضوع لسبر أغواره بعيدا عن الضجيج الإعلامي (الإنترنتي بالأساس)، في حين لم توفر مراكز البحث الغربية جهدا في إلقاء الضوء على جوانب الأزمة، ووضع الحلول المتاحة أمام من يعنيهم الأمر.
من الملا حظات أيضا، أنه ورغم تقارير أممية، بينها تقارير عدة للأمم المتحدة، وكعادة منتهكي حقوق الإنسان فى كل مكان «نعرف»، لم يتورع المسئولون البورميون في إنكار القصة برمتها (!) متهمين كالعادة وسائل الإعلام بالمبالغة والكذب، معتبرين بكل بساطة أن «صور وكالات الأنباء العالمية غير صحيحة»، وأنها متحيزة تعمل لصالح جهات تستهدف أمن البلاد (!).
أما الدروس فكثيرة:
١ـ أن أوضاع الدول المسلمة، أو بالأحرى نظم الحكم في البلاد المسلمة، جعلت من مليار مسلم لا وزن يذكر لهم في ميزان العلاقات الدولية.
٢ـ أنه حيثما تعمقت ثقافة الاستبداد، تصبح «القوة فوق العدل»، بل وفوق الإنسانية ذاتها. سواء تمثلت تلك القوة معنويا في هيمنة التطرف الديني، أو عسكريا في سيطرة الديكتاتورية العسكرية على مقاليد الحكم. وميانمار التي يحكمها العسكر (واقعيا) منذ نصف قرن، وتتحكم فيها أفكار بوذية متطرفة مثال نموذجي على ذلك.
٣ـ أن الإرث الاستعماري الغربي ثقيل وصعب. ولو لم تنجح جمهوريات ما بعد الاستقلال والتحرير في أن تتطهر من أثاره (بتعميق الديموقراطية وحقوق الإنسان) ستبقى الدول التي خضعت يوما للاستعمار متخلفة وضعيفة وهشة أمام متطلبات العصر.
٣ـ أن التسامح الذي تدعو إليه كل الأديان والعقائد، لم يحل أبدا دون تصاعد مشاعر تعصب وعنصرية، تسفر عن عنف دموي يكون من المفارقة أن يتم تحت رايات الأديان والعقائد تلك ذاتها. إذ لعله من الصادم لكل أولئك الذين يعرفون عن البوذية طقوسها المتأملة في صفاء الطبيعة، أن تكون هي أداة الحشد الجامعة لحركة ٩٦٩ المتطرفة التي تستهدف مسلمي الروهينجا جنوب غرب ميانمار.
٤ـ أن الإعلام «الجوبلزي» الأسود، المروج لخطاب الكراهية كان، كما كان دأبه عبر التاريخ مشعل الحرائق الأول. (أعمال الشغب التي اندلعت مستهدفة المسلمين عام ١٩٣٨ كان وقودها مانشيتات الصحف).
٥ـ قد لا نكون بصدد البحث في مدى إمكانية سحب جائزة نوبل للسلام من الزعيمة البورمية أونج سان سو تشى (حصلت عليها وقت أن كانت مضطهدة، وتخضع للإقامة الجبرية في بلادها) ، كما قد نتفهم ما ورد في بيان ستكهولم من أن «لجنة نوبل تقيم جهود شخص ما، إلى حين منحه الجائزة فقط، وليس بعد منحها». ولكن الناظر إلى الصورة من بعد لابد وأن يصدمه كيف تنهار الأفكار النبيلة أمام سطوة التطرف الديني «البوذي في هذه الحالة»، والديكتاتورية العسكرية (التي تحكم بورما منذ نصف قرن).
٦ـ أن ما قد يبدو «استقرارا» تأتي به الديكتاتورية (كما هو الحال في بورما)، ليس أكثر من استقرار زائف. فالإقصاء والتهميش والمظالم التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا ستصب في نهاية المطاف فى مصلحة خطاب عولمي متطرف (سيكون في الأغلب بلا ضابط ولا رابط) يجيش هذا وذاك للثأر «لأشقائنا المسلمين». في تكرار ممل وأحمق لما جرى فى البوسنة والشيشان. (لا تنسوا أن «العالم أصبح قرية صغيرة» كما جاء في صدر هذا المقال).
***
لا تنسوا أن ما يتعرض له مسلمو الروهينجا سيصب في نهاية المطاف في مصلحة خطاب عولمي متطرف في تكرار أحمق لما جري في البوسنة والشيشان
كما هي القصة المعتادة، (فالمقدمات ذاتها تؤدي إلى النتائج ذاتها) لم يكن غريبا ما قرأناه أو بالأحرى ما شهدناه من «تسجيلات فيديو» بدأت تنتشر لعطاء الله أبو عمار؛ الذي قيل أنه قائد «جيش إنقاذ روهينجا آراكان» والذي تم تشكيله للدفاع عن مسلمي الروهينجا المحرمين من الجنسية وحرية التنقل. ويقول تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنهم يتعرضون لما يمكن اعتباره «جرائم ضد الإنسانية»، تصل إلى حد القتل والاغتصاب الجماعي.
في رسالته المتلفزة (التي أشار لها تقرير للـ BBC) يقول عطاء الله أبو عمار: «لا يمكننا أن نضيء الأنوار ليلا، ولا يمكننا التنقل من مكان لآخر خلال النهار. هم ببساطة لا يسمحون لنا أن نعيش كآدميين … إذا لم نحصل على حقوقنا، وإذا تطلب الأمر موت مليون، أو مليون ونصف المليون، أو كل الروهينجا، سنموت، لنحصل على حقوقنا، سنحارب الحكومة العسكرية المستبدة».
هي إذن القصة ذاتها.. المقدمات ذاتها، والنتائج ذاتها. «ودائرة العنف الجهنمية ذاتها».. ولا أحد يتعلم.
أما كيف يمكن لمجتمع ما أن يخرج «متعافيا» من دائرة الثأر الجهنمية تلك، فالإجابة عنوانها «العدالة الانتقالية»، وهي المفهوم الذي خصص له كاتبو الدستور المصري الحالي مادة مستقلة (المادة ٢٤١) أهملها من بيده مقاليد الأمور، أو بالأحرى انتهكها كما انتهك غيرها من مواد.. ولكن تلك قصة أخرى.
***
وبعد..
فلا فارق إلا في التفاصيل بين ما يرتكبه الجيش البورمي في مسلمي الروهينجا، وما فعله مقاتلو الدولة «الإسلامية» في آيزيديي العراق وأمثالهم. بل ولا فارق بين هذا وذاك، وبين ما فعله حافظ الأسد في «حماة» (١٩٨٢)، أو صدام حسين في أكراد حلبجة (١٩٨٨)، أو ما يُروج عن ما فعله بعض الحشد الشعبي في سنة العراق. وبالضبط كما لا تختلف في التحليل النهائي جريمة «الترانسفير» الصهيوني بحق عرب فلسطين، عن جريمة «الحل النهائي» التي ارتكبها النازي في حق اليهود.
هي الجريمة ذاتها. وهي العقلية ذاتها التي لا تعترف بحق الآخر في أن يكون مختلفا، وبحق الآخر في المساواة.
هي الجريمة ذاتها، حين تغتر السلطة بقوتها، والأغلبية بكثرتها، ، والجند بسلاحهم
هي الجريمة ذاتها، حين لا تعترف هذه السلطة أو تلك بمعنى المواطنة، وحين تكره تعبير «حقوق الإنسان».
هي الجريمة ذاتها، وإن اختلف قدر الجرم والتفاصيل حين لا تعرف المعنى الحقيقي «للمواطنة» فتحول بين هذا أو ذاك وبين تولي وظيفة يستحقها لا لسبب إلا لكونه قبطيا، أو شيعيا، أو شيوعيا، أو بهائيا، أو يقال بتبنيه «أفكار» الإخوان المسلمين.
هي الجريمة ذاتها، حين ينسى القابع فى السلطة المغتر بقوته أنه في النهاية «إنسان»، فلا يطيق تعبير «حقوق الإنسان».
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الكاتب:
twitter: @a_sayyad
Facebook: AymanAlSayyad.Page
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
روابط ذات صلة:
International Crisis Group - ICG
Human Rights Watch