الأمن الفكرى
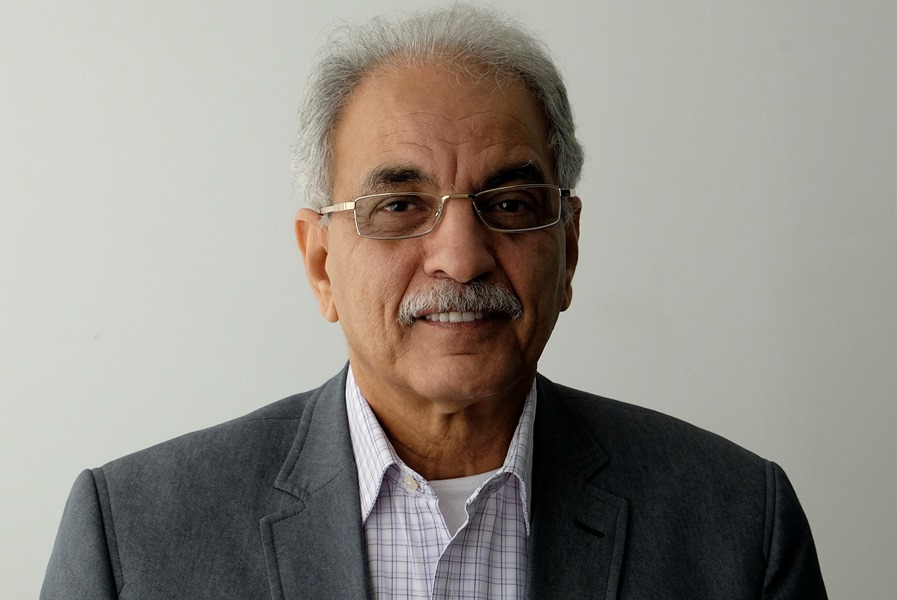 إكرام لمعي
إكرام لمعي
آخر تحديث:
الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 11:00 م
بتوقيت القاهرة
ظهر مصطلح الأمن الفكرى منذ عدة سنوات، وكان الغرض من تحقيقه أن يكون لطبقات المجتمع جميع نوع من القدرة على تمييز الغث من الثمين، وذلك فى مواجهة الأفكار التى تُعرض عليه، أو يتعرض لها من خلال وسائل الإعلام، وقد استهدف الأمن الفكرى من بين الطبقات الاجتماعية الشرائح العليا فى التأثير كرجال الدين (أئمة المساجد وكهنة وقساوسة الكنائس، والمعلمين والسياسيين... إلخ)، لكن تحقيق الأمن الفكرى فشل لأنه وُلد فى ظل ظروف طارئة، أو قل بسبب ظروف معينة كرد فعل للأعمال الإرهابية التى تقع من وقت لآخر، ولذلك كان مضمونه الأوحد والأساسى هو مواجهة الفكر الجهادى والتكفيرى المنتشر بين شرائح عدة فى المجتمع لا يمكن تحديدها، فقد امتدت من متوسطى التعليم إلى الحاصلين على الدكتوراه مرورا بأطباء ومهندسين ورجال أعمال... إلخ ثم اتسعت الفكرة ليصبح مضمونها الأساسى مواجهة الفكر الجهادى والتكفيرى المنتشر بين شرائح واسعة من المتدينين، ثم اتسع أكثر عندما تحول من مجرد محاربة الإرهاب فقط إلى مواجهة ما دُعى بـ«الغزو الثقافى» والحفاظ على النقاء الفكرى للمواطنين. إذا يمكن القول أن المشروع له صيغتان، صيغة أصيلة ضيقة تتعلق حصرا فى الفكر الذى يؤدى إلى الإرهاب بأشكاله كافة، بداية من الإرهاب الاجتماعى كالاعتداءات على خصوصيات البشر ونهاية بما هو مناف للصحيح والقويم من الفكر والسلوك، وقد نجح هذا المشروع بحسب هذه الصيغة فى محاربة الإرهاب، لكن المشكلة هى فى محاولة وضع صياغة موسعة للمشروع أطلق عليها لسبب أو آخر، صحيح أو غير صحيح، إنها تتصدى لأفكار دخيلة ووافدة ومشبوهة، وهنا يصبح المشروع الأصلى مشروعا آخر تماما، بل يمكننا القول إنه مشروع منافٍ للمشروع الأول، فالصيغة الموسعة تحول الأمن الفكرى من حالة ذاتية إلى حالة موضوعية؛ حيث أشعر أنا بالتهديد لأن هناك طرفا آخر مُهدد وليس أنا، أى بعبارة أخرى يجعل شعورى مأخوذا من طرف ثالث وهذه كارثة، وهذا الأمر ذاته هو الذى سمح للفكر الإرهابى أن ينمو فى المجتمع، أى اقتناع أفراد المجتمع بأن أمنهم الفكرى ينبع من تشخيص وتقويم طرف آخر بالخوف عليه، وليس من الخوف الشخصى أو الذاتى، فإذا كان الأمن الفكرى هدفا فلابد من تحرير المجتمع من هذه الفكرة وإقناعه بأن لا أحد له الحق أن يشخص مخاوف الآخر ويضع له العلاج.
***
لكن العجيب أنه بسبب هذه الفكرة الغريبة وغير الموضوعية والخطيرة انفجرت أزمة ترجمات الكتاب المقدس، فقد ظهر فيها من يظنون أنهم أوصياء على البشر، والمقصود بالترجمات هنا ترجمات الكتاب المقدس إلى اللغة العربية الكلاسيكية، فمن المعروف أن الكتاب المقدس مكتوب فى أصوله بلغات عبرية ويونانية وآرامية، وقد تُرجم الكتاب المقدس من هذه اللغات الأصلية إلى اللغة العربية فى سياق الحضارة الإسلامية، فكان هناك تشابه مع نصوص ومصطلحات ولغة وخلفية القرآن، وذلك منذ دخول العرب إلى مصر والشرق الأوسط فى القرن السابع الميلادى، واستمرت هذه الترجمات بخلفيتها (عربية اللغة إسلامية الحضارة) حتى القرن التاسع عشر عندما احتُلت هذه البلاد من الإمبراطورية البريطانية والفرنسية، من هنا أراد المحتلون أن تكون هناك لغتان للعرب واحدة للمسلمين وأخرى للمسيحيين، أو قل مفردات ولهجات، وهكذا بدأت تنتشر لغة ومفردات ولهجات للمسيحيين تختلف عن لهجات المسلمين، فى تلك الأجواء، تمت ترجمة الكتاب المقدس للعربية لكن الذى قام بها شخص أمريكى مستشرق فى بيروت لبنان يدعى ڤان دايك، ومعه فى اللغة العربية بطرس البستانى ومعهم شيخ مسلم لضبط قواعد اللغة العربية، وبالفعل أنجزوا ترجمة كاملة بهذه المفردات ودعيت باسم ڤان دايك.
من هنا نجد أنفسنا أمام تيارين لترجمات الكتاب المقدس للمسيحيين العرب، التيار المسيحى العربى الأصل، والذى امتزج باللغة العربية بعد دخول الإسلام لبلادنا، والذى استمر هو الأسلوب الوحيد للترجمة حتى وقع الغزو الغربى للمنطقة فى القرن 19، فصنع تيارا مختلفا هو المسيحى ذو الثقافة الغربية اللاتينية وهى الجذور للإنجليزية والفرنسية والألمانية... إلخ، ومن هنا صار خطان للترجمة، ترجمة مسيحية عربية الأصل والحضارة، وأخرى ترجمة مسيحية لاتينية الأصل والحضارة، ولقد انتشرت الترجمة الغربية منذ منتصف القرن الماضى حتى اليوم، ولذلك عندما حاول آخرون أن يعيدوا التواصل مع الحضارة العربية المسيحية الأصيلة لتمتد إلى أيامنا هذه، قامت ثورة أولئك الذين اعتبروا أن ترجمة الكتاب المقدس بخلفية الحضارة اللاتينية المسيحية والتى عمرها 150 سنة فقط هى الأصل والتاريخ بينما تجاهلوا أن الأصل والتاريخ يرجع إلى الترجمات التى تمت من القرن التاسع الميلادى وحتى القرن التاسع عشر، ولقد جاء هذا الأمر نتيجة أن هناك من يظن أنه أكثر علما وفكرا من الآخرين وقد استشرف الخطر عليهم وأراد حمايتهم، وذلك تطبيقا للتفسير الخاطئ والمعيب لمصطلح «الأمن الفكرى» ــ عنوان المقال ــ فقد قاموا بتحديد المشكلة لشعوبهم وقدموا الحل لها، قام هؤلاء الأوصياء يحذرون رجل الشارع من ما يُسمى «ترجمات الكتاب المقدس» لأنه يريد إعادة ترجمة الكتاب المقدس للأصول العربية المسيحية، من هنا ندرك أن مصطلح «الأمن الفكرى» خرج عن إطاره واعتبر المصريين أطفالا وعلينا أن نحذرهم من هذا الوباء، وهذه النوعية من التفكير «تفكير الوصايا» للبعض سواء سياسيا أو فكريا أو دينيا على المجموع، أطلق عليه العلماء والفلاسفة «التقسيم المثنوى» والذى يعنى أن الليل يقابله النهار، والشرق يقابله الغرب، والذكر يقابله الأنثى، فهل يعنى ذلك أن الشر يقابله الخير، والإنسان يقابله الحيوان؟ لا شك أن هذه الثنائيات لا تُعبر عن الإنسان المتحضر الذكى؟ فالتقسيم المثنوى صبغ طريقة تفكيرنا وقيدها من زمن بعيد، وهذا هو ما أورثنا الانحراف والضياع والغباء، فى حين أن الغرب المتحضر والذى كان يفكر مثلنا لم يتحضر إلا عندما وضع الثنائيات جانبا وأطلق عقله بالتفكير قافزا فوقها جميعا، فشطب من قاموسه وطريقة حياته مبدأ «إما أو» فعندما يناقشون أمرا ما يطرحون كل الاحتمالات بين الأبيض والأسود وما بينهما، وما قبلهما، وما بعدهما من درجات الألوان، من هنا قبلوا بعضهم بعضا بغض النظر عن العرق (أسود – أبيض – أصفر)، ولذلك صارت حقوق حيواناتهم لا تقل عن حقوق الإنسان، قبلوا الحيوانات والطيور وجميع الثقافات وأتباع الأديان، يرحبون بكل فكر جديد ورؤيا جديدة، يتحاورون حولها بانفتاح وإنسانية، يبحثون عما يقربهم ولا يبعدهم، ويقبلون بعضهم بعضا على المستوى الإنسانى، لذلك هناك تتعايش كل الأديان، وكل دين يتعايش مع تعدد طوائفه، وكل طائفة تتعايش مع كل الأفكار المطروحة، وهذا التعايش يَختبر يوميا ما يصلح له وما يرفضه، والذى يقبله مقبول والذى يرفضه مقبول أيضا إنسانيا طالما هناك فرد واحد يتبناه، من أجل هذه النوعية من التفكير مع استخدام البدائل وصلوا إلى القمر والمريخ ووصلوا إلى قمة التكنولوجيا والحرية، بل وصلوا إلى قمة الإنسانية فى العلاقات، فلا يوجد إنسان مرفوض ولا فكر مرفوض، لقد وضعوا جانبا فقه ولاهوت القطيع، ولم يتوقفوا لحظة عن الحوار حول ما يتفقون فيه وما يختلفون عليه، وفى حالة الاختلاف والاتفاق يعملون لأجل مستقبل أفضل بتفهم أفضل، وذلك لتحقيق إنسانية أفضل.
***
لذلك ما كان فى الخيال صار بالإمكان، وما كان بالإمكان أصبح فى حالة الفعل والإنجاز، والذى لم يكن فى الإمكان صار فى دائرة الإمكان، أمام هذه التجربة الإنسانية التى نجحت فى معظم بلاد العالم أمريكا وأوروبا، واليابان والهند وسنغافورة وهونج كونج وفى جنوب إفريقيا وكينيا، وباقى دول العالم، لم يعد سوانا نلهث وراءهم، ونتساءل لماذا نحن هكذا؟ نريد أن نصل لتحضرهم لكننا ننسى أهم عامل للتحضر وهو ما فعله هؤلاء تاريخيا، وما يفعلونه حاليا لأجل مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة. أما أن يقف المسئولون عن الشعب المصرى «الطفل» كما هو فى أعين الأوصياء: لا تلتفت، لا تقرأ، لا تحاول فأنت مازلت طفلا صغيرا ونحن نعرف مصلحتك أكثر منك وبسبب هذا المنطق، هناك شعوب تمتد عبر الزمن، وشعوب تنقرض وأديان وفلسفات تمتد وتتطور وأخرى تنقرض، والعيب ليس فى الإيمان والفلسفات لكن فى التوجه الإنسانى الراقى الصحيح.