كلما فتح العقل بابًا أغلقناه بالغيب
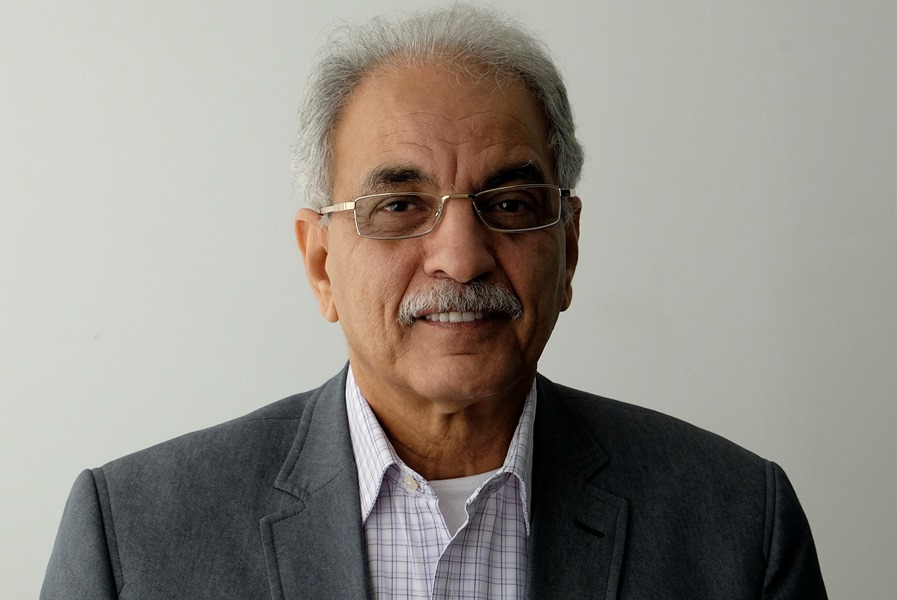 إكرام لمعي
إكرام لمعي
آخر تحديث:
الجمعة 12 يوليه 2019 - 9:50 م
بتوقيت القاهرة
هناك تعبير يتداوله قادة الجيوش المتحاربة بهدف رفع الروح المعنوية لجنودهم، إنه لكى تنتصر فى معركتك لابد من «شيطنة العدو»، والمقصود بشيطنة العدو تشجيع الجيش المقاتل على أن مهمتهم مقدسة ضد جيش من الكفار، وبالتالى لابد من إبادته دون أى إحساس بالندم أو التردد لأنهم أعداء الله، وهذا بغض النظر عن تدين الجيش من عدمه.
عادة تندلع الحروب بسبب نزاع سياسى، أو اختلاف أيديولوجى مثل الحروب الصليبية، أو الصراع بين السنة والشيعة، أو صراع على أرض مشتركة... إلخ. وعلى الرغم من كل ذلك التنوع لابد من استدعاء الدين، والسؤال لماذا؟ والإجابة: لأنه من الضرورى تأجيج العواطف الدينية، والانفعالات، واستنفار واستنهاض الهمم، لذلك تلجأ الدول إلى الدين فى لحظات ضعفها وتنساه فى لحظات قوتها وتحضرها. ليس هذا فقط، بل إن الدين يحمل سر ضعف الشعوب، وذلك حين لا تقدر قياداتها على كبح جماح اندفاعاتها نحو حرب ترى شعوبها عدم جدواها، فمثلا ترى الشعوب أن غزو دولة عربية أو إسلامية لدولة عربية أو إسلامية أخرى أمر مرفوض ولا معنى له، لكن القيادات لها رؤى أخرى لأسباب أيديولوجية (شيعة ــ سنة) أو اقتصادية (بترول ــ مصادر ثروة) أو سياسية (زعامة على منطقة)... إلخ. فكيف تقنع قيادات هذه الشعوب شعوبها إلا بإشعال الصدور، وبعث ما فى القبور، بعظات دينية تقوم بـ«شيطنة العدو»، فيحل قتله وتدميره، يتبع ذلك مسيرات شعبية هائجة مندفعة وينتهى المشهد بالصدام بين الذين يستدعون الدين كوسيلة (السياسيون والمنظرون والحكام)، وبين المتدينين الذين يعتبرون أن حروبهم دينية فى سبيل الله، وهنا من يجرؤ على نزع عمامة المقاومة الدينية دون نزع البندقية من أيدى حامليها؟! وفى كل مرة يعاد فيها هذا السيناريو، يعود الشعب محبطا متألما يائسا غير مدرك أبعاد هذه اللعبة السياسية الكونية. لقد استخدم الدين لإسقاط ليبيا وسوريا والعراق واليمن ومصر وتونس، لكن عند حسم المعركة، يجلس السياسيون لينهوا النزاع، ويقسموا الأراضى والغنائم والسلطان.
***
إن التوجه الدينى ينشئ وينتج مجتمع الطاعة، وهو ما قد يكون مفيدا فى مرحلة ما لتجييش الجيوش، لكن الإنسان ابن الحضارة الإنسانية وبانيها هو الذى يعلم أن الدين هو جزء من الحياة السياسية، مثلما أن العاطفة جزء من العقل، كما أن خطاب العقل لن يكون مجرد خطاب عاطفى وانفعالى، كذلك لا يمكن للخطاب السياسى أن يكون مجرد خطاب دينى لمجرد شحذ المواقف وتجييش الانفعالات.
إن ما يحدث اليوم هو ما دعا أفلاطون فى كتابه «الجمهورية» إلى تحييد الشعر والشعراء من مجال صناعة القرار السياسى لأنها مجرد عواطف، فالانفعالات تقتل السياسة، وتحطم أسس المدينة والدولة، لذلك كان أفلاطون حريصا على أن يقوم بنيان الجمهورية على أساس النفس العاقلة، ووضع النفس العاقلة فوق النفس الغاضبة والنفس الشهوانية. هو هنا يستبعد سلطة الانفعالات سواء كانت دينية أو غير دينية عن القرار السياسى. ذلك لأن أكبر خطر على صحة القرارات السياسية هى العواطف الإنسانية.
لو عدنا بالتاريخ عدة عقود نجد أنه لم يكن بإمكان أى زعيم سياسى فى أى دولة متقدمة أن يستحضر الحجج القبلية أو الدينية لتبرير اختياراته. لم يكن ممكنا أن يتجرأ أى رئيس دولة عظمى على انتهاج سلوك سياسى معين بدعوى أن الله هو من أمره بذلك. أما اليوم فقد أصبح من الشائع أن يستعين قادة الدول وزعماؤها بالحجج الدينية والأدعية والصلوات قبل أن يحددوا اختياراتهم أو يدافعوا عنها أمام الناس. تاريخيا نجد أن الخطاب السياسى لرجال الدولة كان يمثل حقلا مستقلا عن معتقداتهم وقناعاتهم ومشاعرهم الدينية. كان الحقل السياسى لديه القدرة على تحييد المشاعر والانفعالات، بالطبع لم يكن الدين أيا كان غائبا عن الحياة السياسية، لكن كان تحييد الدين عن سلطة القرار السياسى موجودا، ولو فى الحدود الدنيا الممكنة إلى وقت قريب. من اللافت للنظر أن هرتزل فى كتابه «الدولة اليهودية» ألتى دعا إليها على الرغم من أنها تجسد إحدى الحقائق الدينية إلا أن الرجل لم يشعر بالحاجة للاستعانة بأى حجة من الحجج الدينية، ولم يتضمن الكتاب أى رمز أو مفهوم يحيل إلى اليهودية كدين، ولا إلى أى دين آخر. وفوق هذا وذاك كان الرجل واضحا وصريحا فى دعوته إلى ألا يكون لرجال الدين اليهود أى نوع من السلطة داخل إسرائيل. كما أنه اقترح علما وطنيا لا يتضمن أى رمز دينى عدا أن يكون أبيض اللون، وبسبعة نجوم إشارة إلى ساعات العمل اليومية. مع كل هذه الاحتياطات والتى استعارها من أفلاطون ووضعها لتأسيس دولة إسرائيل، إلا أن ذلك لم يصمد أمام النزوات والانفعالات الدينية لمعظم العائدين إلى أورشليم، وكانت الكلمة الأخيرة لأصوات الحماسة الدينية، ولنظرية الحق الإلهى.
***
من الأمور التى تثير العجب أن خطابنا السياسى عندما يتحدث عن مصطلحات عصرية لا علاقة لها بالدين من قبيل الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو الحرب من أجل النفط، فإننا نجد أن الخطاب السياسى لا يتردد فى الاستعانة بالحجج والمبررات الدينية والغيبية.
فى زيارة رسمية للرئيس الفرنسى الاسبق نيكولاس ساركوزى للفاتيكان عام 2007 وهى الأولى من نوعها لرئيس فرنسى منذ إقرار قانون العلمانية عام 1905، صرح أمام رجال الدين داخل الفاتيكان بأن «العلمانية لم ولن تستطيع أن تجتث فرنسا من جذورها الكاثوليكية المسيحية، وقد حاولت ذلك كثيرا لكنها فشلت».
وهل كانت الثورة الإيرانية عام 1979 تقصد أن تقول شيئا آخر غير أن ملوك إيران قد حاولوا أن يجتثوا إيران عن جذورها الإسلامية ولم يستطيعوا؟!
إن القادة والزعماء الذين شقوا طريقهم نحو السلطة فى الشرق الأوسط وتركيا وإيران، وصلوا للحكم من خلال تجييش المشاعر الدينية للشعوب، للناخبين والجماهير، وهؤلاء قد يحققون نجاحا فى جعل الناس أكثر انقيادا لأوامرهم وقراراتهم عندما يصيغونها بصورة توحى بأنها أوامر من عند الله، وترضى الضمير الدينى.
لكن هذا الرهان يكون مؤقتا ومرتهنا بظروف العنف والمواجهة فى إطار من المزايدة على التيارات الدينية المتشددة. لكن فى حالة ما إذا فاق الرهان حجم الأهداف الموضوعة وإمكانية تحقيقها (الأوضاع الاقتصادية الصعبة،او اكتشاف كم غير مسبوق من الفساد،وطعن المصداقية فى مقتل، والفشل المتكرر فى علاج القضايا) قد ينقلب السلاح على حامليه وذلك حين تتوارى قوى العقل، وإرادة الحياة أمام مغامرات كبرى، يعتقد القائمون عليها وبها أنها توافق المشيئة الإلهية حتى النهاية. هنا تنهار مشروعية المساومة، والتوافق، والتعاقد، والعيش المشترك أمام سلطة الوصايا المقدسة، فتتحول السياسة من فن الممكن إلى واجب السمع والطاعة والانقياد فتقع الطامة الكبرى والتى لا نجاة منها وهو ما لا نتمناه على أية حال لاى دولة من الدول.